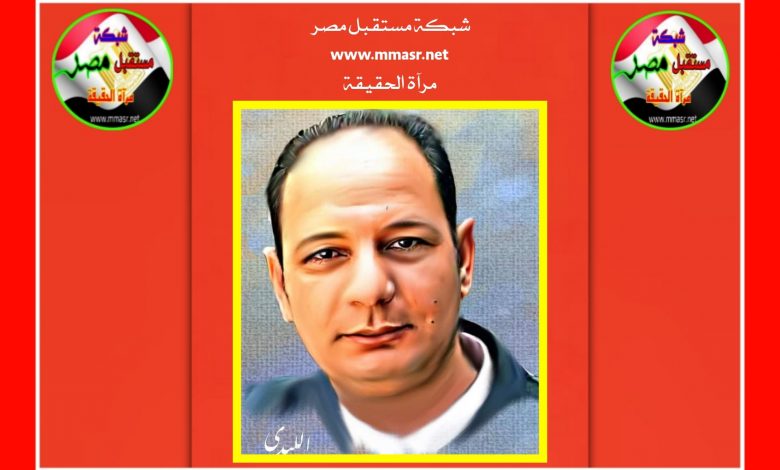
بقلم: عمرو الزيات
سيق من العنوان أن موضوع القصة اجتماعي يرصد الحالة الاجتماعية لتلك الطبقة التي تتخذ من حارة ( أم كحلة ولبانة) مأوى(تكية) لها، وفي إشارة خفية لطبيعة تلك الحارة كان لابد من اختيار هذا الاسم تحديدا دون غيره؛ هذا الاسم الذي يلخص دلالات كثيرة اختزلها القاص، فهو يلمح ويترك للمتلقي استنتاج تلك الدلالات (أم كحلة) الكحل رمز الحسن والتزين والدلال؛ بيد أنه آض – في هذا البيئة الاجتماعية معنى جديدا؛ فهو يعني محاولة اجتذاب الذكور، كما يعني أن الكحل أحد مقومات حرفة بيع الهوى في ذلكم المكان الذي لا يملك قاطنوه إلا الحلم وما بين أفخاذهم، وحين يغتال الواقع أحلام الفقراء فإن السبيل إلى السعادة هي المرأة (في حارة يسكنها الشبق!).
ولأن الأديب ابن مجتمعه لا يعيش بمعزل عن واقعه نجد أن صاحبنا يرصد تلك النماذج البشرية في براعة؛ فنراه يغوص في أعماق الشخصيات؛ ليجسد تلك النزعات النفسية التي تعتمل في النفوس (تمر الأيام وأهل الحارة مشغولون باكتساب قوتهم من خلال حرف بسيطة يقومون بها ،لا يكاد يمر يوم دون شجار أو معركة حامية الوطيس أحد أطرافها العدوي حبيب حلاوتهم وأتباعه وطرفها الآخر حسن الملواني عشيق كيداهم ورواد “قهوته “التي كان يؤمها الحرافيش من كل مكان وخصوصا ليلتي الاثنين والخميس تنبعث منها أدخنة المعسل القص المحوج بيضاء تنتشي على أثرها النفوس المكدودة وتستريح على كراسيها الأبدان المهدودة!)
يعتبر الرمز الملاذ الذي يلجأ إليه الأديب في عصرنا، ينفث من خلاله ما يعتمل في نفسه من آلام وآمال، وللرمز قيمة فنية وجمالية يشعر بها المتلقي حين يفك تلك الشفرات؛ لينفذ إلى أعماق المبدع والنص. وفي رأينا أن العملية الإبداعية لا تؤتي ثمارها المرجوة من المتعة الفنية، وترسيخ القيم الهادفة إلا إذا صاحبها جهدٌ من الطرفين: المبدع والمتلقي معًا، وقد يقول قائل: المبدع يبذل جهدًا ليخرج عمله كما يريد.. هذا معلوم، ففيمَ يبذل المتلقي الجهد؟!
اعلم أيها القارئ، أنك لن تشعر بالمتعة الفنية، ولن يفضي إليك النص بأسراره ما لم تمنحه التأمل وحسن المعاشرة، وما المانع إن أعطيتَه من وقتك القليل، ومن جهدك اليسير الذي لا يقاس بما يبذله الأديب في إبداعه؟ وصدق المازني حين قال: أبذل ( في الكتابة ) من جسمي ونفسى، ومن يومي وأمسى، ومن عقلي وحسى، وأقدمه لك.
وغير خاف على ذي بصر أن صاحبنا يجيد توظيف الرمز دون إلغاز أو تعمية على القارئ؛ بل إن كل الرموز يفسرها السياق وهي وليدة القصة وموضوعها، يظهر هذا جليا في (أم كحلة) كما يبدو في ذلك التوظيف العجيب لكلمة ( التكية)
تعددت الشخوص في القصة، وقد يرى بعض النقاد أن كثرة الشخوص في القصة القصيرة قد يغض من جمالها، ويضعف من بنائها؛ غير أن صاحبنا جعل من شخوصه قواعد يقوم عليها البناء الفني لقصته، وجاءت كلها أساسية لا يمكن الاستغناء عنها؛ بل إن محاولة الاستغناء عن بعضها يزلزل ذلك البناء الشاهق.
وحين تتعدد الشخصيات يتنوع – حتما – الحوار الذي يكشف عن جوانب الشخصية، ويرصد حالتها الاجتماعية وميولها النفسية، إضافة إلى نمو أحداث القصة ومرورا بالعقدة ووصولا إلى لحظة التنوير، ومن أمارات المهارة لدى صاحبنا أنه لم يتدخل في الحوار، واكتفى بدور الراوي، فلم يقل كلمة واحدة، وإن كانت كلمات الحوار كلماته، كما أن القصة ابنته من صلبه: فكرة ونسجا ولغة وخيالا.
لصاحبنا – في إبداعه السردي – تجربة جديرة بالدرس، ونعني بها المزج بين اللغة الفصحى واللغة العامية، وهي ظاهرة ليست جديدة على أدبنا المعاصر؛ بيد أن صديقنا يجيد هذا المزج؛ فيستخدم العامية على لسان شخوصه في مواضع لا تستطيع الفصحى نقل ما يريده دلالات وإيحاءات؛ ورغم أن صاحبنا من أنصار الفصحى بوصفها الهوية التي تعبر عنا وعنه، وهي الجسر الذي ما زال يربط بيننا وبين ماضينا وموروثنا وحضارتنا التليدة، ويرى – ونحن معه – أننا إذا فرطنا في الفصحى فقد قضينا على كل ما يربطنا بذلكم الماضي وتلكم الحضارة، رغم كل ذلك فلا يجد صاحبنا غضاضة في استعمال بعض الألفاظ العامية التي تعبر عن واقعنا المعيش؛ لكنها يستخدمها لهدف واضح، وليس انتصارا أو تمجيدا لها ، وحين يستخدمها يبتعد عن المبتذل منه؛ فهو يحترم القراء ويحترم فنه.
حمادة عبد الونيس لا يمثل إلا ذاته المبدعة، لا يكتب – حين يكتب – إلا بإيعاز منها، ولا يكتب إلا ما يراه، لا يلتفت لأنصاف البشر، يجلّ العلماء؛ بيد أنه ليس ظلا ولا تابعا يذوب في غيره وقد يختلف مع هؤلاء العلماء، يؤمن أننا جميعا بشر لا يلازمنا الصواب، وله أسلوب معروف يعبر عن شخصيته، تعرف أنه صاحبه وإن لم يُوقع باسمه، وتلك سمة كبار النفوس.





